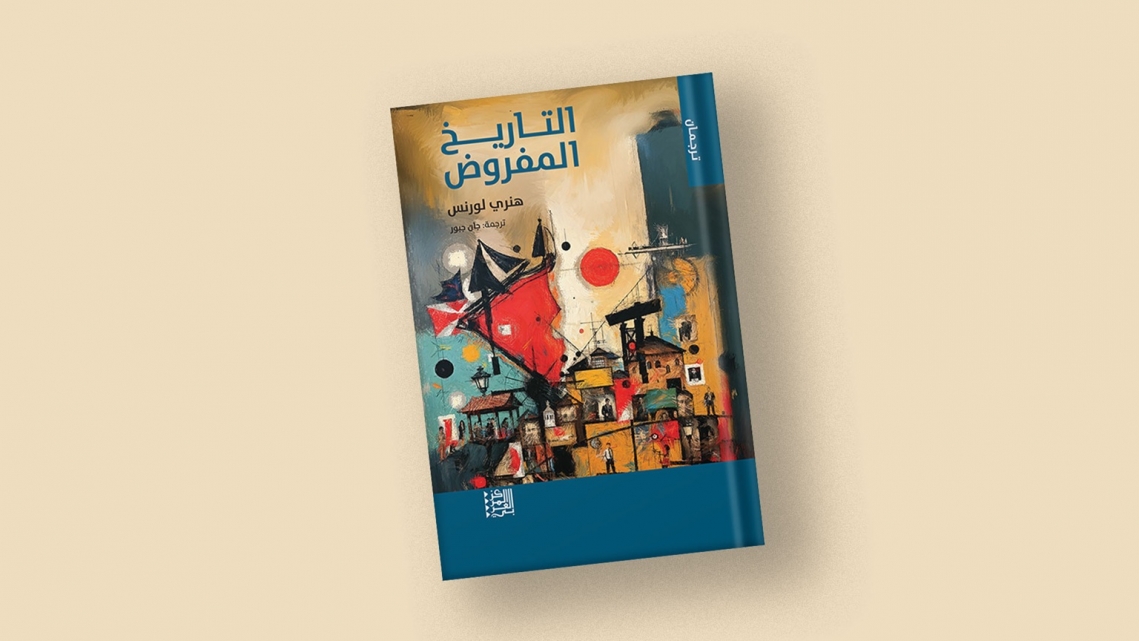
تدوين- أسماء العزبي
في زمن يُدار فيه العالم بقوة الحكاية أكثر من سلطة القانون، وتُعاد صياغة الذاكرة تحت وطأة الانتصارات المادية، لا يعود "التاريخ" مجرد سجلّ لما جرى، بل يتحوّل إلى ساحة حرب تُخاض بالرموز والسرديات. في هذا السياق الملتبس، الذي تتشابك فيه خيوط السرد والسلطة، يقدّم المؤرخ الفرنسي البارز هنري لورنس، أستاذ تاريخ العالم العربي المعاصر في "كوليج دو فرانس"، إسهامه النقدي الجديد عبر كتابه "التاريخ المفروض"، الصادر حديثاً عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بترجمة جان جبور ضمن سلسلة "ترجمان".
لا يكتفي هذا الكتاب بتقديم رواية مضادة للتاريخ الرسمي الغربي تجاه الشرق، بل يخوض مباشرة في مساءلة مفهوم "التاريخ" ذاته: من يمتلك حق كتابته؟ ومن يُمنح صكّ الكلمة؟ ومن يُقصى إلى هوامش النسيان؟ يضع لورنس الذاكرة الإنسانية على طاولة التشريح، مؤكداً أنها لم تعد مستودعاً للماضي، بل غدت "مسرحاً" يتنازع فيه الأقوياء على معنى وذاكرة الضعفاء.
التاريخ كسلاح: تفكيك لـ "عقلانية" الإبادة
منذ افتتاحيته، يضع لورنس القارئ أمام حقيقة مؤلمة: التاريخ ليس أرشيفاً محايداً للوقائع، بل هو ميدان صراع تُصاغ فيه حكايات الأمم على ألسنة المنتصرين. يتجاوز السؤال التقليدي "ماذا جرى؟" ليصبح "من الذي قال إن هذا ما جرى؟"، منتقلاً بالتأريخ من خانة التوثيق إلى فضاء النقد الجذري لآليات السرد نفسها.
تكمن خطورة طرح لورنس في كشفه ليس فقط لتزييف الرواية الاستعمارية، بل في فضحه لمنظومة التفكير التي أنتجت هذا التزييف وألبسته رداء العقلانية. فالعنف، في قراءته الصادمة، ليس نتاجاً لاندفاع همجي غريزي كما تحب الخطابات الرسمية أن تُصوّره، بل هو توليد مباشر للعقل ذاته حين يَستبدّ به التنظيم والتبرير.
ويذهب لورنس إلى أبعد من ذلك، ليكشف عن المفارقة المُرّة التي تسكن قلب الحداثة الغربية: "العقل الذي ابتكر الهندسة والفن والسياسة، هو ذاته الذي صاغ هندسة الإبادة، وكتب بروتوكولات القصف، وشيّد معسكرات الموت، كل ذلك باسم النظام والعقل والإنسان". بناءً على هذا، تصبح الحرب ليست نقيضاً للحضارة، بل إحدى تجلياتها القصوى، لحظة صدقٍ يسقط فيها القناع عن الوجه الحقيقي للتاريخ، ويتجلّى الإنسان في أقصى تناقضاته: صانع الجمال ومهندس الدمار في آنٍ واحد.

صراع الذاكرة: عنف النسيان والاحتفاظ بالمعنى
لا يتوقف "التاريخ المفروض" عند حدود تحليل العنف السياسي أو العسكري، بل يتعمق في بُعده الثقافي والنفسي. يرى لورنس أن التاريخ هو بالأساس صراع على الذاكرة. وما يُحذف أو يُمحى من الذاكرة لا يقلّ فداحةً عما يُرتكب على أرض الواقع، إذ إن احتكار الماضي هو الشرط الأوّل لاحتكار المستقبل. بناءً عليه، فإن "أعنف ما في العنف ليس الرصاص، بل النسيان".
حين تُطمس ذاكرة الشعوب، تُختزل آلامها في لغة الإحصاءات والأرقام الباردة، ويُختصر وجودها في تقارير الحروب وبيانات الإدانة التي تُسكِت الضمير ولا تُنطِقه. عندها، تصبح الذاكرة فعلاً مقاوماً لا يقلّ خطراً عن الثورة المسلحة.
يوجه لورنس بصره نحو "تاريخ المهمّشين"، أولئك الذين لم تُتح لهم فرصة تدوين حياتهم بمدادهم الخاص، والذين كُتبت قصصهم على هوامش الرواية الكبرى. التاريخ الحقيقي، في تصوره، ينبض في أدب المنفى، ورسائل المعتقلين، وشهادات الناجين التي لم يُسمح لها بالانتشار، ليصبح الماضي جرحاً مفتوحاً يُعاد نزفه حتى يُسمَع صوته.
ومع ذلك، يحذر لورنس من أن الذاكرة المضادة نفسها ليست بريئة تماماً من الصراع، إذ يمكن تحويلها إلى سلعة أو شعار يُعاد هندسته لخدمة القوة. عندها يغدو الألم "مُقنّناً"، يُعرض على شاشات الإعلام بوصفه عاطفة سريعة الاستهلاك، في حين يحلّ الرقم البارد محلّ آلاف الحكايات الإنسانية. لذلك، يذكّرنا لورنس بأن المقاومة الحقيقية لا تقتصر على حمل السلاح، بل تمتد لتشمل الاحتفاظ بالمعنى والقدرة على "تسمية الأشياء بأسمائها"، والتمسك بحقّ السرد حين يصادره الآخرون.
سلطة السرد: الضحية ومأزق الاعتراف
في الجزء الأخير من الكتاب، يصل السؤال إلى ذروته الفلسفية: من يملك حقّ تمثيل العنف والمعاناة؟ لا يهدف لورنس إلى تقديم إجابة نهائية بقدر ما يسعى إلى تفكيك البنية العميقة التي تُنتج السؤال ذاته. فتمثيل المعاناة، سواء في الأدب أو الفن أو الإعلام، ليس مجرد فعل جمالي، بل هو صراع على سلطة السرد: مَن يُمنح حقّ الكلام؟ ومتى؟ وبأي لغة؟
في هذا المنظور، لا يعود التاريخ مجرد ميدان للأحداث الماضية، بل ساحة دائمة لإعادة إنتاج السلطة من خلال اللغة. ويكشف لورنس عن مأزق ما بعد الاستعمار، حيث "لا يُسمح للضحية بالحديث إلا ضمن حدود يضعها النظام ذاته"، يُسمح لها بالرواية بشرط ألا تطالب بالعدالة، وأن تبقى في إطار الشهادة دون الفعل. وهكذا، يُعاد إخضاع المهمّشين تحت مسمّى "الاعتراف بهم"، ويُحوَّل الألم إلى مشهد رمزي يخدم السردية الكبرى ويُثبّتها، بدلاً من أن يزعزع أركانها.
هذا التحليل العميق هو ما يجعل من "التاريخ المفروض" نصاً يتجاوز حدود التخصص الأكاديمي، ليصبح تأملاً فلسفياً في جوهر الذاكرة والسلطة. لورنس لا يكتفي بنقد الوثيقة التاريخية، بل يُعيد مساءلة معنى الكتابة نفسها: لمن نكتب؟ وهل يمكن للتاريخ أن يكون فعلَ عدالة لا مجرّد سجلّ للوقائع؟ لورنس هنا لا يقدّم نفسه كمؤرّخ محايد، بل كـ "شاهدٍ واعٍ" بأن الحياد في هذه المعركة ليس إلا ضرباً من المشاركة في التزييف.

نداء لاستعادة الذاكرة: صرخة ضدّ السيطرة الخفية
يختتم "التاريخ المفروض" كصرخة ضد تزييف الذاكرة الإنسانية، وضد اختزال الألم إلى أرقام، وضد تحويل المعاناة إلى مادة إعلامية سريعة الزوال. إنه نداء لاستعادة حقّ الكلام من براثن الصمت، ودعوة لتأسيس تاريخ جديد يُروى فيه الإنسان كفاعل وشاهد على حكاية العالم، لا كـ "موضوع" للاستعراض.
في عالمنا المعاصر، حيث تُعاد كتابة التاريخ كل يوم وفق مصالح الحاضر ورواية المنتصر، يذكّرنا لورنس بأن أخطر أشكال العنف هي تلك التي لا تُرى: أن يُقال للضحية كيف تتحدث، وأن يُفرض على الشعوب كيف تتذكّر. إن "التاريخ المفروض" هو هذا الشكل الخفيّ من السيطرة، الذي لا يُمارَس بالقوة الجسدية، بل بسلطة المعنى المُحتكَر.
لا يقدّم لورنس وصفة جاهزة للمصالحة، بل يقترح فعلاً مقاوماً من نوع آخر: مقاومة بالسرد، وبالاستعادة، وبالتفكير، وبالتمسك بحق الإنسان في ذاكرته. فالتاريخ الذي يُراد له أن يكون سرداً ناعماً للانتصارات، يجب أن يُعاد فتحه ليصبح سجلّاً للأوجاع، لأن الحقيقة لا تُبنى إلا على الاعتراف، والعدالة الحقة لا تتحقق إلا حين يُمنح الصامتون حقّ الكلام.
يتركنا المؤرخ الفرنسي في النهاية أمام سؤال مفتوح: "هل نكتب التاريخ لنُفسّر العالم، أم لنُبرّره؟" في هذا السؤال يكمن شرف التأريخ، وفي الإجابة عليه يتحدّد مصير الذاكرة البشرية وكرامة السرد الإنساني. هذا الكتاب ليس مجرد نقد أكاديمي، بل هو وثيقة ضمير، ودعوة جريئة لإعادة النظر في طريقة روايتنا للعالم وفي الطريقة التي نصنع بها أبطالنا وضحايانا. ففي كل رواية مفروضة، ثمة رواية أُخرى تُخنق، وفي كل تاريخ رسمي، يظل هناك تاريخ ظلّي ينتظر أن يُكتَب بدم الذين لم تُتح لهم فرصة الكتابة.