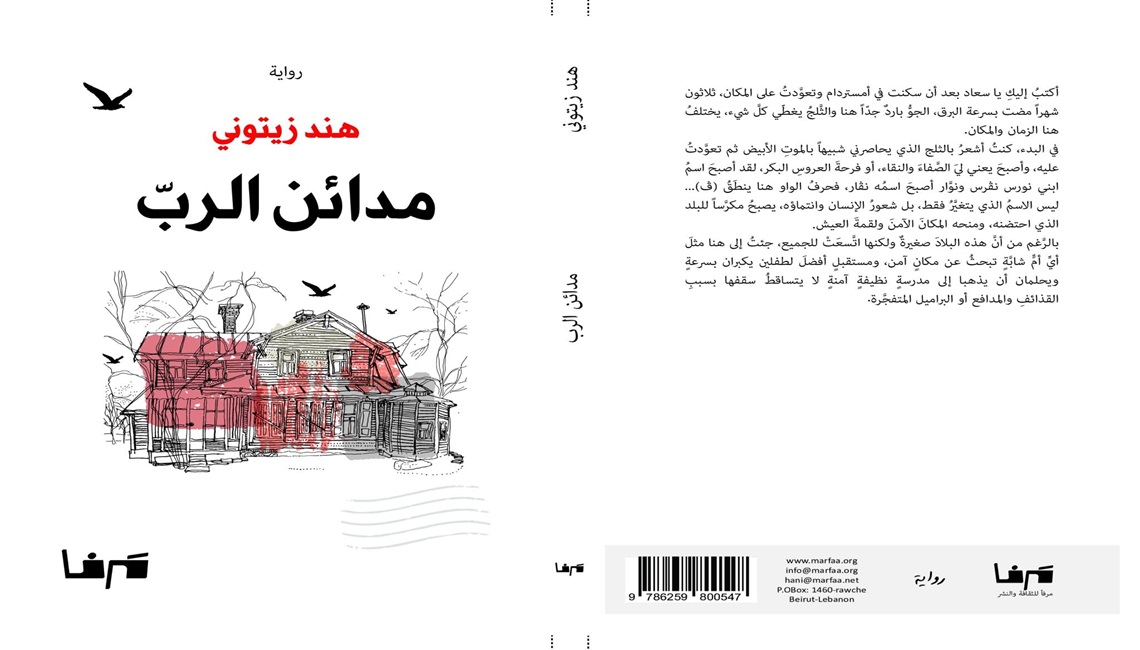
تدوين- فراس حج محمد
تأتي رواية "مدائن الربّ" للكاتبة هند زيتوني بعد أحد عشر عملا مطبوعاً، منها ثلاثة أعمال روائية، وتتناول الكاتبة فيها المأساة السورية التي تجاوز عمرها ثلاثة عشر عاماً الآن (2024) زمن النشر، وتتألف الرواية من أربعة فصول، (الانتفاضة، والحرب، ونون النسوة، والحصار)، وكل فصل مقسم إلى مجموعة من العناوين القصيرة التي تعالج بطريقتها بعض مظاهر المسألة السورية منذ اندلاعها عام 2011، والمراحل التي مرّت فيها، وتطوراتها من الانتفاضة السلمية إلى الاقتتال، وما فيه من مآسٍ داخلية، ثم دفع الناس إلى الرحيل، والخروج من نيران الحرب؛ إما خوفا من البطش، وإما بحثا عن حياة مستقرة، بعيدا عن الوضع السيّئ الذي تعيشه سوريا في هذه الأثناء.
ولعلّ هذه الطريقة من توزيع الرواية على وحدات سردية صغيرة جاء متأثرا بطبيعة هذه الحرب، ومعبّرا عمّا آلت إليه من تفتيت الجغرافيا السورية، وتشظّي الإنسان السوري على المستوى الذاتي، وعلى مستوى الأسرة، وصولا إلى تسلّط رموز النظام والعناصر المسلّحة، وتفكك المجتمع وتحويله إلى مجموعات متنازعة، لا تعرف الهدوء، ولا الاستقرار، فالرواية تدين الجميع وتحملهم مسؤولية كل هذا الذي حدث، ولا تنتصر لطرف على طرف، إنما كأنها تصور بكل دقة ما يجري، وتلتقط عدستها كل تلك المشاهد لتضع بعضها بجانب بعض مؤلفة مشهدا مأساوية لا أحد رابح فيه إلا الخراب والدمار.
يحيل عنوان الرواية القارئ إلى مدائن صالح؛ مدائن عاد وثمود، تلك التي دُمرت بعد عزّ وسلطان، وأصبحت في التاريخ الإسلامي مكاناً "ملعوناً"؛ ورد في الحديث الشريف: "لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم". عدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة- رضوان الله عليهم- عندما استقوا من ماء بئر الناقة وعجنوا به عجينهم أن يلقوا العجين ويهرقوا ذلك الماء.
وغير بعيد عن "أرض الحجر" مدائن كسرى، تلك المدينة التي كانت أيضا محلا لإيوان ملك الفرس العظيم كسرى أنو شروان، ولم يبق منها شاهدا عليها إلا بعض الآثار، وهكذا هي سوريا اليوم، كما تبدو صورتها في الرواية مكاناً لا حياة فيه، ولم يبق من دليل على حضارته إلا بعض آثاره التي تتخايل في النص وتبدو آثارا شاحبة، لا تظهر جلية في الرواية، لأن الحرب قد مسحت معالمها كلها؛ القديمة والحديثة، ولم يبق سوى صور الدمار والدخان، وفي إضافتها إلى "الربّ"، إما إدانة لتلك المجموعات الدينية المسلحة التي هدمتها باسم الدين، لا، كما هو حال "مدائن صالح" التي تهدمت نتيجة عصيان أهلها أوامر نبيهم، كأنها بذلك تتناص تناصا معكوسا مع القصة القرآنية، وإما إجلالا لقدرها تشبيها لها بمدائن كسرى، فهي بالتالي تحمل دلالة مزدوجة، وهاتان الدلالتان تحملان شعورين متناقضين بالضرورة، تحسّرا على مآلها المعاصر، والنقمة على كل من ساهم بجعل هذه المدن/ المدائن السورية مثالا حيا للـديستوبيا المعاصرة التي لا شيء فيها لا يشير إلا إلى الحزن، ولا تثير إلا مشاعر البؤس والاشمئزاز.
تقوم الرواية على مجموعة من الأشخاص الموزعين في المنافي أو الموجودين في سوريا، وعلاقة المغتربين أو الفارّين من الحرب بالمكان الجديد، وعلاقتهم بالمكان القديم بعد تلك الأحداث التي وقعت في سوريا، التي غيرت المكان وناسه، وترسم الرواية شبكة علاقة بينيّة بين هؤلاء الأشخاص، ومن خلال هذه العلاقات تبدو جوانب أخرى من جوانب هذا الواقع المتشكل بفعل هذه الحرب التي أنهكت الشعب السوري والتراث الثقافي والفكري للحضارة العربية على أرض سوريا.
يبدأ زمن القصّ في مفتتح الرواية بشهر نيسان 2013، لكنه يرتدّ إلى عام 2011، وتجاوز ذلك إلى نهاية عام 2015، فالرواية تتناول خمس سنوات من عمر الأحداث السورية، وتداعيات تلك الأحداث، ولا تلتزم الرواية الخط التاريخي التصاعدي "الزمن الكورنولوجي" لرسم الأحداث، فتداخل الزمن، كما تداخلت الجغرافيات، كما هو حال المسألة السياسية نفسها التي شابها التداخل والفوضى والاضطراب، وتداخل الشخصيات وتعقيدات مسارها النفسي جرّاء الأحداث وما جرّته من مصائب.
يظهر الهمّ النسوي في الرواية واضحاً، من خلال تسليط الرواية الضوء على ما تعانيه النساء في الحرب من مصاعب وأهوال وأزمات نفسية واقتصادية، وما تتعرض له من عنف، واستغلال، بحيث تبدو المرأة في الرواية من أكثر فئات المجتمع تضررا في مثل هذه الظروف، ولأجل هذا الغرض كانت شخصياتها النسوية كثيرة وفاعلة وممثلة لأدوار متعددة في المجتمع؛ مريم وسعاد وليال وسهير وسمراء، ليكنّ بطلات الحدث الروائي بحقيقة ما يرمزن إليه في المجتمع أولا، وما يمثلنه في البنية الروائية ثانياً، وفي الدلالة على الفكرة التي تنطلق منها الرواية بشكل عام ثالثاً.
كما تظهر بعض تلك الأفكار ذات الطابع النسويّ في رسالة مريم الثالثة لأختها، واصفة تصرّف زوجها، وكيف يريد أن يعاملها بعد أن انضم إليها وإلى أولادها في أمستردام، ومواجهتها له، رافضة كل طلباته التي تقيد حركتها أو ممارسة حياتها كما تريد، فكما كتبت في رسالتها "أنا الآن امرأة حرة لا أقبلُ أن أعيش على هامش الحياة بلا معنى ولا هدف، ولا أقبل لأي شخص أن يسجنني في قفص ويقف بوجه طموحي".
وظفت الكاتبة أسلوب اليوميات بطريقة مغايرة، بحيث لم تؤرّخ للأحداث، بدقة، لكنها كانت منقادة إلى فكرة الحدث اليومي وما فيه من مستجدات في حياة الشخصيات، ومن خلاله سردت، وبنت أحداث روايتها، ومع هذا الأسلوب استخدمت أسلوب الرسائل، فكان هناك ستّ رسائل، أربع منها لمريم المغتربة في مدينة أمستردام في هولندا ترسلها إلى أختها سعاد الباقية في دمشق، وتردّ عليها أختها برسالة واحدة عام 2015، معبرة فيها عن رغبتها في الذهاب إلى هولندا لتبتعد عن بلد الجحيم، ويعود زمن أول رسالة لمريم إلى شهر آذار من عام 2011، ثم رسالة في كانون الأول 2012، ورسالة ثالثة في كانون الأول 2013، ورسالة رابعة في نهاية عام 2015، ومن اللافت للنظر أن هذه الرسائل- عدا الأولى منها- جاءت كلها في الشهر الأخير من العام الذي أرسلت فيه، وأما الأولى فكانت تعود بالقارئ إلى بدايات الحدث السياسي في سوريا عام 2011، حيث اندلاع الثورة في منتصف شهر آذار من هذا العام، لتبدو تلك الرسائل كأنها علامات تاريخية وإنسانية لتلك الأحداث، فلعل مريم كانت ترى أن ثمة أملا للخلاص مع اقتراب نهاية العام والدخول في عام جديد، ولعلها من غريب المصادفات الأدبية أو التنبؤات التي تمنحها التجربة لكتّابها أن يكون هذا الشهر (كانون أول) هو الشهر الذي حققت فيه الثورة السورية ما كانت تطمح له وتسعى إلى تحقيقه، حيث انهار النظام السابق، وفرّ معظم رموزه خارج سوريا، فحمل الثامن من هذا الشهر (ديسمبر) ميلاد عهد جديد لمدائن الربّ السورية.
أما الرسالة السادسة فكانت من أحلام، إلى طلال، وهي رسالة قصيرة، لكنها تقارن بين البلد التي ذهبت إليه حيث إنه بلد له قوانينه، وليس كما هي سوريا التي انتشرت فيها الجماعات المسلحة، ولا يحكمها القانون.
تنتمي رواية "مدائن الرب" إلى مجموعة من الروايات التي كتبها الأدباء السوريون التي جعلت الأوضاع في سوريا منذ 2011 قضيتها الأساسية، وتعزّز- تحديداً- اتجاها نسوياً في كتابة الحرب روائياً، فتضاف إلى روايات كل من شهلا العجيلي، ومها حسن، وواحة الراهب، وعبير إسبر، وروزا ياسين حسن، على سبيل المثال لا الحصر، كما تعزز اتجاها كتابيا لدى الكاتبة نفسها التي كتبت عن الحرب شعريا في ديوانها "غواية الدانتيل"، وسبق أن تناولت الديوان بقراءة بحثت فيها ثنائية الحب والحرب، (صحيفة الحدث الفلسطيني، العدد 138، فبراير، 2021).
تحضر في البنية السردية لمدائن الرب الشخصيات المنكسرة، الحزينة، الفقيرة، المضطربة، المخذولة، الضائعة، التي اكتوت بويلات تلك الأحداث قبل الاغتراب من القهر والإذلال والاعتقال، وملاحقة العناصر المسلحة، لذلك فهي تحلم بالفرار من سوريا، تاركة بلد الحضارات العريقة بلدا مهدما، لكنها لم تجد الباب مفتوحاً أو السبيل ميسّرا، فثمة معاناة أخرى تعترض هؤلاء الباحثين عن نجاة خارج وطنهم، إذ يتعرضون للموت غرقا، وهم يأملون في عبور البحر إلى الضفة الأخرى، حيث بلاد الأحلام والاستقرار، والعيش الرغيد
تتخذ الروائية من "البيت السعيد" استعارة لما يحدث في سوريا، ومن خلال هذا الفضاء المكاني ناقشت هذا الانكسار في الشخصية السورية بعد الحرب، كما ورد على لسان ليال تلك الفتاة التي تحولت إلى بنت ليلٍ: "جسدي ملوّث، وروحي أحرقها هؤلاء الأوغاد، ولذا لم يتبق لديّ ما أخاف عليه، شرفي تمرّغ بالوحل، وكرامتي هدرت، وزوجي مات. حاولت كثيراً أن أمشي في طريق الطهارة والعفة، ولكن كان هناك دوماً حجر عثرة في طريقي إلى أن أصبح جداراً طويلاً، لم تمكني الظروف من تجاوزه، وكأنّ القدر رسم لي حياةً اختارها لي ولم يبقَ لديّ أية حلول أخرى".
هذه الفقرة التي جاءت في نهايات الفصل الثالث المعنون بنون النسوة، تلخص الفصلين الأول والثاني، وتمهّد للفصل الأخير المعنون بالحصار، إذ تزداد حدة الأحداث سوءا في رسم عوالم سوداء روحية وواقعية للشخصيات، تعبر عنها الرواية في ستة عناوين فرعية، لتنتهي الأحداث باختفاء ليال، وهروب سمراء أخت طلال، ومن ثَم رحيله وهو يتحسر على وطن هدمته الحرب، وجعلته خراباً.
لم تهدم هذه الحرب البنايات والوطن، بل هدّمت الإنسان أيضاً، وبالتالي فإن هذه الرواية تقدم صورة قاتمة سوداء للحربِ، وتجعل من دمشق المدينة العريقة، بل سوريا كلها من شمالها إلى جنوبها، ومن غربها إلى شرقها "ديستوبيا" بكل ما يعنيه هذا المفهوم من فوضى وخراب، وخوف، وبلد اللا قانون، ومستقبل مجهول لا يُعلم له نهاية، بمقابل بلد المنفى، على سبيل المثال أمستردام حيث وجدت فيها مريم حريتها، وأعادت اكتشاف ذاتها.
بهذه الأوصاف وصف طلال مدن سوريا مـتأملا تلك المشاهد، وهو متجه ليخرج منها: "هذه الحرب اللعينة التي تركت آثارها المدمرة في كل المدن، حيث الأبنية المهدمة والشوارع المحفورة بالقنابل والألغام والمتفجرات، وانهيار البنى التحتية، والضحايا البشرية، والتداعيات النفسية، والخوف الذي زرعته صفارات الإنذار في قلوب الأطفال. هؤلاء الأبرياء الذين عاشوا تحت سماء محروقة وجربوا العطش والجوع وذاقوا مرارة اليأس وارتعشت أجسادهم البريئة، من البرد وأصوات المدافع".
وعلى الرغم من هذه الصورة البائسة المستمرة منذ اشتعال الحرب في سوريا وإلى زمن كتابة الرواية وصدورها، فإن الكاتبة هند زيتوني لم تفقد الأمل في الغد المشرق، فأنهت الرواية بهذه الفقرة: "لا بد أن تشرق الشمس في مساحاتها المحجوبة بغيم الطارئين لتغدو كما كانت من قبل فراديس أرضية، ورغم كل هذا الكم من الحزن والويلات والدمار الذي خلفته الحرب من حولك لا زال هناك بارقة أمل وغيمة فرح تلوّح لك بيدها لتمطر أمناً وسلاماً ومحبة".
لا شكّ في أن الحنين لسوريا ما قبل الهدم هو حلم يراود كل الكتّاب السوريين، بل وكل المثقفين العرب، لعلّ سوريا تشفى من جراحها التي أعمل فيها الجميع مباضعه ليتركوها مفككة، تئنّ، لكنها لن تموت وستعود مشرقة، إنه أكبر من حلم، إنه يقين الفكر المؤمن بالتعافي والنهوض من بعد هذه الكبوة التي قدّمت فيها سوريا، الشعب والحضارة والتاريخ أثمانا باهظة. فهل بدأت شمس سوريا بالشروق بعد الثامن من ديسمبر عام 2024؟