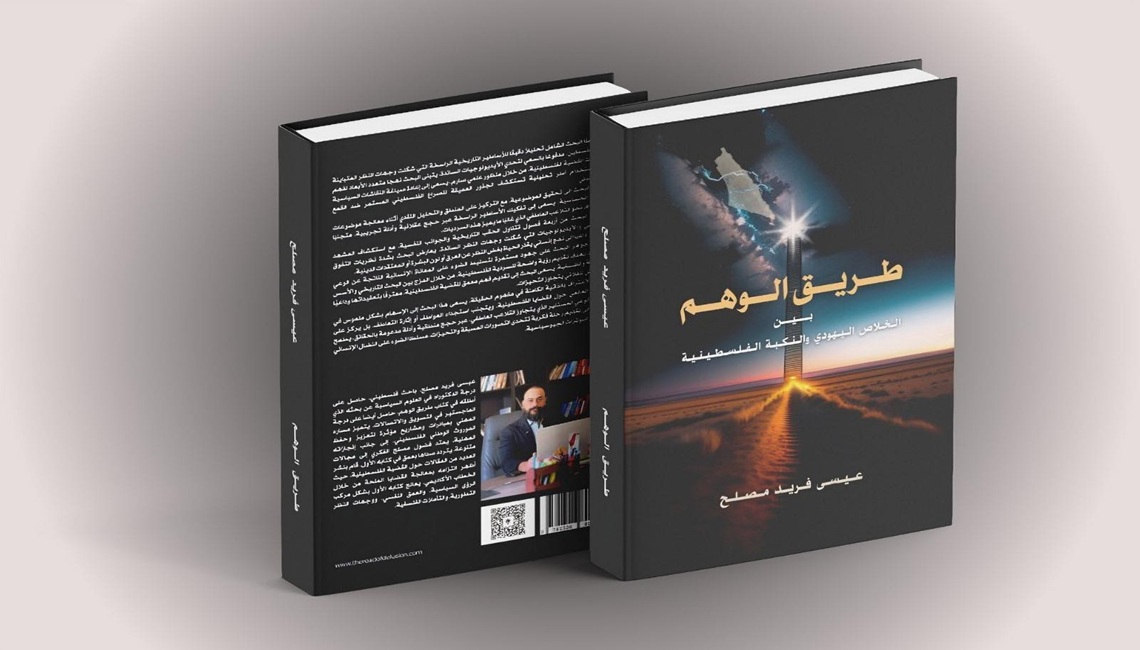
تدوين- آراء ومدونات
كان العصر البرونزي المتأخِّر في كنعان فترة مضطربة سياسيّاً واجتماعيّاً؛ إذ خَضعَت كنعان للسيطرة المصريّة. فَرَض المصريّون سيطرتهم على المدن الرئيسيّة في كنعان من خلال حُكّام مَحلِّيِّين عملوا كولاة لهم، يديرون شؤون المدن نيابة عن السُّلطة المصريّة. حافَظ هذا النظام الإداري المصري على الاستقرار النسبي في بعض المناطق، لكنّه كان هشّـاً أمام التحدِّيات الإقليميّة.
في هذا السياق المضطرب، ظَهرَت مجموعات تُعرف باسم "الخابيرو" أو "العبيرو" (المصطلح المصري: أبيرو)[1]، التي وَرَد ذكْرها في وثائق متعدّدة من الشرق الأدنى، من نصوص ماري (القرن 18 ق.م.) إلى أرشيف تل العمارنة[2] (القرن 14 ق.م.).
تُشير رسائل تل العمارنة إلى جماعة تُدعى الخابيرو، وذُكروا في عدة رسائل بوصفهم مَصدر اضطراب في المنطقة. إحدى هذه الرسائل هي EA) 286)، حيث كَتَب عبد خيبا، حاكِم أورشليم، إلى المَلك المصري يشكو من تهديد الخابيرو لمدينته، قائلاً: «إلى المَلك، سيِّدي، قُلتُ: "عبدك عبد خيبا. أَسجُد عند قَدمَيّ سيِّدي المَلك سبع مرَّات وأكثَر. سيِّدي المَلك، لقد أعطيتني المدينة، ولكن الآن استولى عليها جماعة "الخابيرو". سيِّدي الملك، أنا الآن في ضِيق شديد"»Pritchard, 1969) ؛ خلاصة قِصَّة رسائل تل العمارنة، 2021).
يبدو أن المصريِّين استخدموا هذا المصطلح للإشارة إلى جماعات أو شعوب أجنبيّة تعيش على هامش المجتمع الكنعاني، دون الإشارة إلى جماعة إثنيّة محدَّدة. قد تكون هذه الجماعات مكوَّنة من مهاجرين، لاجئين، أو حتّى عصابات من المحاربين أو العُمّال المستَعْبَدين. كانوا يتنقَّلون بين المناطق، أحياناً كمرتزقة أو عُمّال مزارع، وأحياناً كغزاة أو قُطّاع طُرُق ولصوص، ممّا جعَلهم عنصراً مقلقاً للسُّلطات القائمة (Lemche 1992; Liverani 2014).
العبرانيّون
في سفر التكوين (14:13)، وردَت صفة "عبري" لأوَّل مرّة للإشارة إلى إبراهيم (أبرام "العبراني")، حيث عبَّرت عن هويّته كشخص مهاجِر ومترحِل. كان هذا الاستخدام الأوَّلي للصفة مرتبطاً بفكرة التنقُّل والهجرة، أكثر من كونه تعبيراً عن انتماء قومي أو إثني محدَّد. يُعتقد أن مصطلح "عبري" اِشتُق من الجذر الساميّ "عَبَر"، الذي يعني "عَبَر" أو "اِجتاز"، ممّا يَعكس حياة الترحال والتنقُّل التي مَيَّزَت إبراهيم وأتباعه، كما هي موصوفة في النصوص العبريّة.
لاحقاً، تطوَّر استخدام هذه الصفة ليشمل بني إسرائيل، فخلال وجودهم المزعوم في مصر، أَصبح المصطلح وسيلة لتحديد هُويّتهم كجماعة متميِّزة عن المصريِّين ثقافيّاً واجتماعيّاً، وظَهَر هذا التمييز بوضوح في قِصَّة يوسف حين وُصف بــ"العبراني" باعتباره أجنبياً ينتمي إلى جماعة مختلفة عن المصريّين.
كان استخدام مصطلح "عبري" في المراحل الأُولى تعبيراً عن صفة اجتماعيّة أكثر منها انتماءً قوميّاً، حيث ارتبط بالمهاجرين أو المجموعات التي تعيش على أطراف المجتمعات المستقرّة. ومع تطوُّر الهُويّة الإسرائيليّة في السرديّة التوراتيّة، تحوَّل المصطلح ليُستخدم كإشارة إلى بني إسرائيل بشكل جماعي.
في فلسطين، استُخدمت صفة "عبري" لتمييز بني إسرائيل عن السكّان الأصليّين وترسيخ رواية الانفصال الثقافي والعِرقي. ففي قصّة شاول، يَظهر المصطلح للدلالة على بني إسرائيل ككيان موحَّد في مواجهة أعدائهم، لكنّه يختفي لاحقاً من النصوص، ما قد يَعكس تحوُّلاً في دلالته أو استبداله بتعابير أخرى. ثم يعود للظهور في أسفار مثل صموئيل الأوّل في سياق الحروب مع الفلسطينيّين، وفي سفر يونان (1:9) حين عَرَّف نفسه كـ"عبراني". ومع تطوّر المجتمع الإسرائيلي، تراجَع استعماله لصالح مصطلحات مثل "إسرائيلي" و"شعب الله".
العلاقة بين الخابيرو والعبرانيِّين
ما زال الجدل التاريخي مستمرّاً حول العلاقة بين الخابيرو والعبرانيِّين، حيث تنقسم الآراء الأكاديميّة بشأن وجود صِلة مباشرة بين المصطلحين. يعزو بعض الباحثين الاختلاف إلى عدم كفاية الأدلّة الأثريّة واللغويّة التي تُثبت وجود علاقة واضحة. يرى باحثون مِثل ديفيد فريدمان أن الأدلّة الحاليّة لا تَدعم وجود رابط مباشر بين الخابيرو والعبرانيِّين. يجادِل هؤلاء بأن الخابيرو، كما يَظهرون في النصوص القديمة مِثل رسائل تل العمارنة، لم يكونوا مجموعة إثنيّة محدَّدة، بل كانوا جماعات اجتماعيّة متنوّعة، تشمل المرتزقة، والعُمّال المستعبَدين، والبدو الرُّحَّل. وفقاً لهذا الطرح، فإن محاوَلة الربط بين المصطلحين قد تكون مبنيّة على تشابه لفظي أكثر من كونها صِلة تاريخيّة حقيقيّة.
على الجانب الآخَر، يقترح عدد من الباحثين أنّ الخابيرو قد يكونون الأساس الذي انبثَق منه العبرانيّون، استناداً إلى التشابُه اللغوي بين Ḫabiru/Apiru وʿIbri/Hebrew، وإلى وجودهم قرب كنعان في الألفيّة الثانية ق.م.
ويليام سميث في كتاب "الإنسان وآلهته" (1952) يَدعم هذا الرأي، موضّحاً أنّ الخابيرو كانوا جماعات بدويّة في جنوب بلاد الرافدين زمن ريم سين ملك لارسا (حوالي 1910 ق.م)، عملوا كمرتزقة للسومريّين، ما يدلّ على قدرتهم على التكيُّف مع النظم الاجتماعيّة والاقتصاديّة. ومن هنا يرى سميث أنّ هذه الجماعة المرنة والمتنقّلة قد تكون النواة الأولى التي تطوَّرَت لاحقاً إلى ما عُرف بالعبرانيّين.
تُظهِر رسائل العمارنة "الخابيرو" كجماعات هامشيّة مقاتِلة داخل كنعان وتَذْكر استيلاءهم على مدن (نَصّ EA 286 لعبد-خيبا عن أورشليم)، وهو ما يوازي تصوير البدايات التوراتيّة للعبرانيّين كـ«غرباء/نُزَلاء» (تكوين: 23:4). بحسب هذا الرأي، يبدو أن كلمة "خابيرو" قد تكون تطوَّرت تدريجيّاً لتصبح "عبري" في السياقات التاريخيّة والدينيّة اللاحقة.
في ذات السياق، يشتكي عبد خيبا أنّ الخابيرو استولوا على أورشليم؛ وهو شاهِد يُثبِت حضور "الخابيرو" في قَلْب كنعان خلال القرن 14 ق.م، أي في البيئة والجغرافيا التي تنسبها النصوص التوراتيّة إلى ظهور "العبرانيين"، وكذلك قَبْل وخلال الإطار الزمني لبدايات إسرائيل المزعومة. هذا التراكب الزمني–المكاني يسهِّل افتراض أنّ بعض «العناصر الإسرائيلية» الأولى كان يوسَم خارجيّاً بـ"الخابيرو".
تُعزَّز هذه الفرضيّة بالوصف الذي وَرَد في سفر التكوين لإبراهيم، حيث يُشار إليه بصفة "عبري"، وهي صفة ارتبطَت بفكرة الهجرة والترحال. تشير هذه الصفة إلى حياة إبراهيم كفرد متنقّل، وهو ما يتّفق مع طبيعة الخابيرو، الذين وُصفوا في النصوص القديمة بأنّهم جماعات تعيش على أطراف المجتمعات المستقرّة وتتنقّل بين المناطق بحثاً عن فرص ارتزاقيّة اقتصاديّة أو عسكريّة.
كما وطَرحَت مدرسة ألبرايت، ثم طوَّرها جورج مندنهال، أنّ «إسرائيل المبكّرة» نشأَت اتّحاداً قبليّاً غير متجانس من عناصر محليّة وهامشيّة (رُحَّل/مرتزقة/فارّين…)، وهو الوصف نفسه الذي تحمِله وثائق الشرق الأدنى عن "الخابيرو". إذا صحّ هذا النموذج الاجتماعي، يصبح رَبْط "العبريين" بإحدى كُتَل "الخابيرو" احتمالاً معقولاً.
تجتمع المعطيات المتاحة لترجِّح أنّ العبرانيّين كانوا إحدى كُتَل الخابيرو ذات الروابط الدينيّة الأمتن؛ ومع مرور الزمن، تخلّوا تدريجيّاً عن نمطهم البدوي، ومع احتماليّة انتقالهم إلى مرحلة الاستقرار في فلسطين، يُرجَّح أن جماعات أخرى قد التحقَت بهم في أواخر العصر البرونزي المتأخّر وبدايات الحديد الأوّل (القرنان 13–12 ق.م).
إذا كان العبرانيّون بالفعل امتداداً لجماعات الخابيرو، فإن ذلك يُعيد رَسْم ملامح تاريخ بني إسرائيل بطريقة مغايرة للرواية التوراتيّة، حيث لا يكون ظهورهم في كنعان نتيجة لغزو خارجي أو هجرة جماعيّة منظَّمة، بل كنتيجة لتطوُّر اجتماعي تدريجي بدأ بكونهم لصوصاً ومُرتزَقة، ثم ربّما استقرّوا تدريجيّاً في أجزاء من كنعان، واندمَجوا في مجتمعاتها المَحلِّيّة، بدلاً من أن يكونوا كياناً منفصلاً فَرَض نفسه على المنطقة بالقوَّة كما تُصَوِّرهم الروايات الدينيّة.
_____________________________________________________________________
[1] مصطلح "الخابيرو" (ويُكتب أيضاً "حابيرو"، والأكثر دِقّة "ʿApiru") يُترجَم إلى "الذين يَعْبرون"، وغالباً ما يُفهم على أنّه يشير إلى البدو أو الجماعات المتنقّلة. يَظهر هذا المصطلح في النصوص القديمة التي تعود إلى الألفيّة الثانية قَبْل الميلاد في مختلف مناطق الهلال الخصيب، ويُستخدم للإشارة إلى مجموعات متنوّعة من الناس. تشمل هذه المجموعات متمرِّدين، خارجين عن القانون، غزاة، مرتزقة، رماة، خدم، مستعبَدين، وعمال. هذا التنوُّع في الاستخدام يشير إلى أن المصطلح كان تعبيراً اجتماعيّاً أو وظيفيّاً أكثر منه إثنيّاً، ممّا يَعكس حياة الأفراد الذين كانوا يعيشون على هامش المجتمع المستقر (Water house, 1965).
[2] وَردت إشارات إلى الخابيرو في مصادر قديمة مِثل رسائل تل العمارنة والنقوش الأوغاريتيّة، حيث تَصف هذه النصوص وجود الخابيرو كمرتزقة يهدِّدون مدن كنعان. على سبيل المثال، تسجِّل رسائل تل العمارنة شكاوى من حُكّام كنعانيِّين إلى الملك المصري حول هجمات الخابيرو، ممّا يُبرز دورهم كعنصر اضطراب في المنطقة. يتناقض تصوير الخابيرو في النصوص الأثريّة مع الرواية التوراتيّة التي تصوِّر بني إسرائيل كجماعة غريبة خرجَت من مصر ودخلّت كنعان في زمن الملك المصري مرنبتاح. يشير الباحثون، مِثل منى (1995)، إلى أن الخابيرو لم يكونوا جماعة محدَّدة بل شملوا طيفاً واسعاً من الأفراد والجماعات الاجتماعيّة. يبدو أن الخابيرو كانوا مجموعة متعدِّدة الوظائف والجذور، وقد لعبوا أدواراً مختلفة في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة للمنطقة.